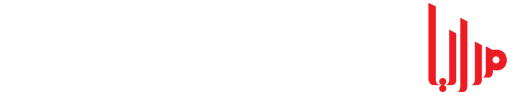انتهت، الجمعة الماضية، محادثات الجولة السادسة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية في مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وبينما دارت المناقشات والحوارات حول مستقبل الدستور السوري، والدولة السورية، والشعب السوري، وقع تفجير إرهابي في دمشق، أسفر عن مقتل 17 جندياً سورياً، ليعصف بتلك الجولة، ويدفع نحو فشلها، بعمل جبان يمثّل خنجراً في ظهر الشعب السوري، وفي ظهر جميع الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة، ومجموعة أستانا، وكافة أصدقاء سوريا، والمتعاطفين مع الشعب السوري.
ووراء الأبواب المغلقة، انتهت المفاوضات، دون إحراز أي تقدّم، دون أن يعرف الشعب السوري من المتسبب الحقيقي في فشل هذه الجولة، بعد خمس جولات سابقة فاشلة، لم تتمكن هي الأخرى من صياغة أفكار ومفاهيم ومبادئ توافقية، قادرة على تقريب وجهات النظر، ولمّ الشمل، ووقف سفك الدماء السورية، وسط خيبة أمل “لافتقار المجتمعين لفهم سليم لطريقة دفع المسار إلى الأمام، وعدم توصل الجولة لتفاهمات وأرضية مشتركة”، وفقاً لتعبير المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.
وبمجرد وقوع الانفجار المشؤوم في دمشق، كان الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قد أعرب هو الآخر عن قلقه إزاء عودة الأطراف المجتمعة إلى لغة الاتهامات المتبادلة، لكنه قال إن جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، قد أسهمت في التغلّب على ذلك، وعادت اللجنة الدستورية إلى “المسار البنّاء”.
إلا أن هذا “المسار البناء”، ومع الأسف الشديد، لم يقدّر له الاستمرار، فيما رأينا لاحقاً من نتائج، أو بدقة أكثر “لا نتائج” الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية، حينما خرج المبعوث الأممي ليؤكد على أن المحادثات “انتهت دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة”، حيث صرّح رئيس وفد الحكومة، أحمد الكزبري، بأن بعض المقترحات المقدمة من المعارضة كانت “منفصلة عن الواقع”، بل عكست في بعض جوانبها “أفكاراً خبيثة وأجندات معادية”. كما لاحظ الوفد الحكومي، وفقاً للكزبري، “إصرار الوفد الآخر ومحاولاته التي لم تتوقف لوضع العراقيل”، وذهب إلى اتهام المعارضة بـ “تشريع كيان الاحتلال الصهيوني وتبرير ودعم الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي أدت إلى إفقار الشعب السوري وتعميق معاناته إضافة إلى تشريع الاحتلالين التركي والأمريكي”.
على الجانب الآخر، صرح رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، بأن “الطرف الممثل لحكومة النظام لم يقدّم أي ورقة للتوافق، بينما أصرّ على أنه لا يرى أي حرف أو أي نقطة للتوافق بخصوصها”، حتى أن بعض النقاط التي تقدمت بها المعارضة، ونقلتها حرفياً عن وفد الحكومة، لتوافقها مع مضمونها بالكامل، عاد وفد الحكومة لرفضها، وهو ما رآه البحرة دليلاً على عدم جديّة وفد الحكومة، وعدم رغبته للتوافق وإيجاد أرضية مشتركة بالأساس.
وكانت وفود اللجنة الدستورية الثلاث (وفد الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني) بواقع 15 عضواً عن كل منهم، قد بدأت أعمال الجولة السادسة الاثنين الماضي في مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وناقشوا خلال الجلسات التي استمرت حتى الجمعة الماضي الأوراق المقدّمة من قبل كل وفد، حيث تقدّم وفد الحكومة بورقتي “السيادة السورية” و”الإرهاب والتطرف”، وتقدّم وفد المعارضة بورقة “الجيش والقوات المسلّحة والأمن والاستخبارات”، وتقدّم وفد المجتمع المدني بورقة مبدأ “سيادة القانون”.
ألقى التفجير الذي حدث في دمشق بظلال مقبضة خبيثة على المجتمعين، وجعل كل منهم يعود سريعاً للبحث عن أرضيته وقواعده الحزبية والشعبية التي ينتمي إليها، ويستقي منها، في واقع الأمر، شرعيته التي جاء إلى جنيف ممثلاً عنها. لينتفي بذلك جوهر الاجتماع والغرض من اللجنة الدستورية، وهو البحث عن أرضية مشتركة جامعة لكل السوريين. فكان الانفجار بمثابة ذريعة لوفد الحكومة كي يقول لوفدي المعارضة والمجتمع المدني: “هذا ما أوصلتنا إليه حريتكم وديمقراطيتكم ومظاهراتكم وثوراتكم المزعومة واستنادكم إلى الدعم الخارجي. وما يعاني منه شعبنا السوري ليس سوى نتيجة منطقية لما يفرضه سادتكم من عقوبات على شعبنا وحكومتنا المنتخبة شرعياً منه”. كذلك كان الانفجار ذريعة كي يقول وفد المعارضة: “هذا نتاج القمع والديكتاتورية وحكم الفرد وتغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات، وعدم استقلالية القضاء، وتزوير الانتخابات وممارسة الخداع الإعلامي المستمر”، كما كان الانفجار ذريعة كي يقول المجتمع المدني: “هذا دليل دامغ على فشل فكرة الدولة، واعتماد المواطن على الحكومة المركزية لتسيّر شؤونه، بينما يستطيع الأفراد فيما بينهم، ويستطيع المجتمع المدني، حتى مع تنوع انتماءاته بين الحكومة والمعارضة، الاضطلاع بمسؤولية الحكم، ولا حاجة لنا لجيش أو سلاح أو حتى حكومة، طالما كانت الدولة مسالمة لا تهدد جيرانها، تعيش في سلام واستقرار وأمن”.
لا أرى الحقيقة في أي من الرؤى الثلاث، التي تمكّن التفجير المجرم من فرزها في التو واللحظة ليضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد. ولم يعد يهمّ هنا حتى من أعلن أو سيعلن مسؤوليته عن التفجير، وإنما المهم هو النتيجة التي ساعد التفجير في تحقيقها، وربما نجح، ولو مؤقتاً، في تحقيقها، وهي عودة كل وفد إلى أرضيته الأيديولوجية/الحزبية. والتي يجب أن تدفعنا، في سياق أي تحقيق نزيه وشفاف في تحديد الجهة أو الجهات التي تقف خلف هذا التفجير، إلى البحث عن المستفيد، أو المستفيدين من ذلك.
أعود وأقول إن أياً من الرؤى الثلاثة لا تحمل الحقيقة، ولا تمثّل طريقاً نحو حلحلة الأزمة السورية، التي تبدأ من الدستور، ولا شيء غير الدستور، تمهيداً للشروع في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. فعلى الرغم مما يبدو على السطح، من ضرورة اللجوء للحلول الأمنية، وتوسيع نطاق المواجهة، والتعقب والاحتراز وتطوير آليات البحث الجنائي، وسرعة معالجة المعلومة الاستخباراتية وطرق الحصول عليها، لدرء المخاطر الإرهابية، إلا أن وقف حمام الدم السوري، وسفك الدماء السورية الطاهرة، لا يبدأ سوى من الدستور.
فالدستور هو ما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، ونزاهة وشفافية الانتخابات وتعيين القضاة. وآليات تطبيق الدستور على الأرض هي ما يضمن عدم “إعادة تدوير النظام”، وفقاً لتعبير المعارضة، ويضمن عدم عودة الأمور إلى منوالها الراهن أبداً. فالتجربة السورية المريرة، والدم السوري الذي أريق بسخاء ليروي تراب الوطن السوري، لابد وأن يدفع أبناء سوريا إلى ما هو أعظم وأقيم وأرفع من كل ما عرفته هذه الأرض من دساتير. وإلا ذهب مع الريح هباءً منثوراً كل ما أريق ولا يزال يراق من دم، وما يعانيه الشعب السوري الأبي من ظلم وقسوة وشظف في العيش.
فالحرية ليست سبة، ولا الديمقراطية عيباً، ولا المظاهرات السلمية البريئة خطراً يستوجب مواجهات أمنية، وإراقة للدماء. وليس كل الدعم الخارجي جاسوسية ولا تخابر، وفي ظل استقرار راسخ، وأمن مستدام، ليس هناك خوف من استثمار خارجي أو تعاون دولي أو إقليمي، فالعالم قد أصبح قرية صغيرة يمكنه أن تعيش فيها الدول في تناغم وتعاضد وتنسيق فيما، وهو ما نراه في مناطق أخرى من العالم، دون أن يسبب ذلك حساسية أو شكوك من “تدخلات” خارجية في شؤون الدول.
كذلك، وفي الوقت نفسه، فهناك أطماع واضحة جليّة ساعدت الأزمة السورية في كشفها وفضحها، فقد رأينا بأم أعيننا كيف تربّحت المؤسسات الصناعية العسكرية الأمريكية بشكل مرعب من الوجود في أفغانستان خلال عشرين سنة مضت، ورأينا كيف أصبحت الموارد الطبيعية السورية وقبلها العراقية مشاعاً يسرقه المغامرون والمحتلّون من كل حدب وصوب، دون وازع من ضمير أو أخلاق أو رادع من القانون الدولي، في وقت استخدم فيه هؤلاء مطية “الحرية” و”الديمقراطية”، لتحقيق أهدافهم الخبيثة في سرقة الموارد الوطنية. لهذا يصبح لزاماً على الدستور السوري أن يحدد مفاهيم السيادة ووحدة الأراضي والسيطرة الأمنية، والاحتراز من التدخلات الأجنبية لا على مستوى الاحتلال العسكري فحسب، وإنما أيضاً على مستوى الاحتلال والتدخل الثقافي والإعلامي، وتدخل رأس المال الأجنبي دون رقيب أو حسيب، فتلك أمور ينبغي أيضاً حسمها، ووضعها في الاعتبار، والنظر بشأنها لا من خلال منظور اللحظة الراهنة، وإنما تطلعاً وتحسّباً للمستقبل.
كما أن الدولة والمجتمع المدني لابد وأن يتكاملان في اضطلاعهما بمسؤولية ضمان حد معقول من مستوى المعيشة للمواطن السوري، بحيث يساعد المجتمع المدني في الوصول إلى المواطن حيث يمكن أن تعجز الدولة، لاتساع نطاق مسؤولياتها، وصعوبة وصولها إلى المواطنين كافة المستويات جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، عن الوصول إليه. كذلك تساعد الدولة المجتمع المدني فيما يعجز هو عن توفيره من إحكام قبضة الأمن، وتطبيق وتعميم قوانين الدولة، وكذلك حماية المجتمع من أي أضرار أو اعتداءات خارجية، تحكمها سياقات التاريخ والجغرافيا، التي لا يمكن الحياة بمعزل عنها.
إن سوريا منطقة ملتهبة بحكم الجغرافيا والتاريخ، وبسبب موقعها وتنوعها العرقي والديني والاجتماعي، والذي يجب أن يؤدي دوره التاريخي كمحرّك للحضارة الإنسانية لا معرقل لها، ولا بد لدستور سوريا الجديدة، أن يضع في اعتباره ذلك التنوع العرقي والطائفي وأن يجعل منه ميزة لا عقبة، من خلال إدراك جميع الأطراف إلى ضرورة امتلاك أجهزة استقبال إلى جانب أجهزة الإرسال، فتستمع الأطراف إلى بعضها البعض، وتحجم عن الإملاءات والشروط. فبعد عشر سنوات ونصف من الحرب التي ابتلعت مئات الآلاف من الضحايا، وملايين المهجّرين والنازحين واللاجئين، ومدن بأكملها طالها الدمار الشامل والجزئي، لا يجب أن يملي أي طرف من أطراف الأزمة السورية أي شروط على أي طرف آخر، وأن يتعامل المتفاوضون جميعاً انطلاقاً من هذه الأرضية، بتجرد نزيه بعيداً عن أي تعصّب، فالمسؤولية جسيمة، والضغط الواقع على الشعب السوري يتعاظم لا كل يوم، بل كل ساعة. ولا حل سوى باستغلال منصة جنيف، على الرغم من خيبة الأمل بفشل الجولة السادسة، بوصفها طوق النجاة لا للقيادة في دمشق فحسب، سعياً منها لرفع الحصار، ودرء مخاطر الفوضى واندلاع الحرب من الجديد، وإنما كذلك للمعارضة، سعياً للمضي قدماً في العملية السياسية، وبدء جهود المعونات الإنسانية واستثمار رأس المال السوري والإقليمي والدولي في عملية إعادة الإعمار، وللمجتمع المدني الذي يتوق لممارسة مهامه في دولة تنعم بالأمن والاستقرار، يستطيع فيها المواطنون السوريون التعبير عن حبهم الحقيقي لوطنهم، ورغبتهم العارمة لبنائه مجدداً في ظل دستور شامل جامع، يحمي حقوقهم، ويحدد واجباتهم، ويرسم ملامح دولتهم الجديدة.
الكاتب والمحلل السياسي/ رامي الشاعر
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
#مرايا_الدولية