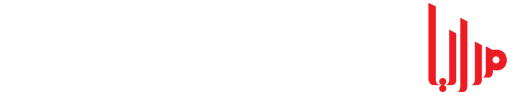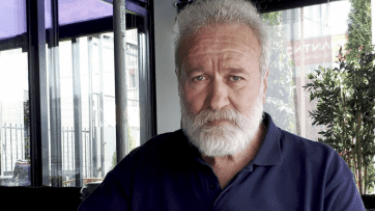
الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر
هل هناك قانون دولي يمكن أن يحرمنا نحن الشعب الفلسطيني من العيش على أرض أهلنا وأجدادنا التاريخية وألّا نحصل على حقوقنا الشرعية العادلة؟
أجد كثيراً منا التوازيات في المواجهة بين روسيا والغرب الجمعي على أرض أوكرانيا بأيدي النازيين الجدد وبين ما يحدث من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي الصهيوني المتحكم بها، وأهم تلك التوازيات هو المحاولات المنهجية لتزييف التاريخ ومحوه والسعي الدائم لفرض سردية تاريخية “جديدة” لوقائع الحرب العالمية الثانية في حالة الأزمة الأوكرانية، ومحو تاريخ فلسطين، وكأن تلك البقعة من الأرض كانت، طوال الوقت، تضم تلك الملايين التي تم جلبها من جميع أنحاء الأرض في إطار المشروع الصهيوني العالمي.
لذا وجب التنويه إلى ذلك التاريخ الذي يشكل جزءاً من هويتنا ووجودنا وكياننا كأمة فلسطينية تسعى للدفاع عن قضيتها الشرعية العادلة، واستعادة أراضيها التاريخية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
لقد بدأت لجنة “وودهيد” الفنية البريطانية عملها قبل 85 عاما من أجل تقديم مقترحات لتقسيم فلسطين الانتدابية، الخاضعة آنذاك لإدارة الاحتلال البريطاني، إلى دولتين عربية ويهودية، وقد رفضت الحكومة البريطانية تقسيم فلسطين، باعتباره قراراً ينطوي على “صعوبات سياسية وإدارية ومالية” لا يمكن التغلب عليها.
بعد هذا التاريخ بـ 9 سنوات، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181، الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني في فلسطين بحلول 1 أغسطس 1948، وأوصى بإنشاء دولتين غير مسميتين على أراضيها، في تحدٍ لتوصيات لجنة “وودهيد”، دولة يهودية وأخرى عربية.
في تلك التوصية/الخطة، التي أغدق فيها من لا يملك على من لا يستحق، تم اقتراح إدارة دولية لمدينتي القدس وبيت لحم، لاحتوائهما على مزارات دينية مهمة، وكان من المفترض أن تتضمن الدولة العربية من الجليل الغربي مع مدينة عكا والمناطق الجبلية في يهودا والسامرة، والساحل الجنوبي لمدينة المجال (عسقلان حالياً، بما في ذلك قطاع غزة الحالي) في الشمال، وقطاع من الصحراء على طول الحدود المصرية، كما دعت الخطة إلى دمج يافا ذات الأغلبية العربية إلى جنوب تل أبيب، داخل الدولة اليهودية، لكن تم تغيير الخطة قبل تصويت الأمم المتحدة وأصبحت المدينة جيبا للدولة العربية.
لم يكن هناك سلام أو اتفاق على الأراضي الفلسطينية منذ البداية، واندلعت صراعات صغيرة بين السكان العرب المحليين والمهاجرين من أوروبا، واتبع الصهاينة نهجاً متشدداً سعياً للاستيلاء على المزيد من الأراضي، بما في ذلك تلك التي لم تكن مخصصة لهم رسمياً وفقا لخطة التقسيم، بل إن غالبية العرب اعتبروا تنفيذ الخطة الدولية في حد ذاته اجتياحاً وقحاً، وهو ما كان بذرة للصراع العربي الإسرائيلي المرير والمشتبك والمعقد والمزمن حتى يومنا هذا على أرض فلسطين الحبيبة.
ومع طول أمد الصراع، وعلى الرغم من الشعارات البرّاقة الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة والشرعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسائر “العالم الحر”، إلا أن إسرائيل، وعلى مسمع ومرأى من الجميع استمرت في احتلال مزيد من الأراضي الشاسعة التي خصصتها الأمم المتحدة للدولة الفلسطينية، وبعد أن عاش على تلك الأراضي أجيال من المستوطنين لسبعة عقود، وضع خلالها الاحتلال الصهيوني العالم أمام معضلة إخراج هؤلاء المستوطنين الغاصبين من الأراضي التي احتلوها بوضع اليد وبالتحايل وبالقوة العسكرية الغاشمة.
وبعد أن بدا وكأن العالم برمته قد “ملّ” من محاولة حل الصراع، جاءنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2020، بما أُطلق عليه “صفقة القرن”، والتي يحمل جوهرها بذرة الفشل التي لا يمكن أن تستقيم معها الأمور، فبدلا من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، التي أقرت بها جميع القرارات الأممية ذات الصلة، نصت خطة ترامب على اعتراف مبدئي بالقدس عاصمة للدولة العربية، إلا أن أراضي هذه العاصمة ستقتصر على الجزء من المناطق العربية الواقع خلف الجدار العازل القائم حاليا، في الوقت الذي أعلن الرئيس الأمريكي فيه عزمه الاعتراف بجميع المستوطنات اليهودية الموجودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كأراضٍ إسرائيلية، واصفا القدس بأنها “العاصمة غير القابلة للتجزئة” لإسرائيل.
في المقابل، طالبت الولايات المتحدة، وكشرط لعملية السلام الوهمية، قيادة السلطة الفلسطينية بالتخلي عن أساليب الكفاح المسح ودعم حركات النضال الوطني مثل حماس والجهاد الإسلامي، وكبادرة لحسن النوايا، ودعما لعملية السلام هذه، وعد أصحاب هذه الخطة بـ 50 مليار دولار للسلطة الفلسطينية.
فشل ترامب ومن معه في شراء الفلسطينيين، ومحو هويتهم وتاريخهم وجوهر قضيتهم، ولا زال الصراع مستمراً كما كان من قبل، إلا أن النقطة وكما كانت من قبل ليست في مدة الصراع ولا في توارثه واستدامته ولا حتى في تفاقمه الدوري، وإنما في استعداد الأطراف للتوصل إلى نوع من الحل العادل والشامل مرة واحدة وتحقيق العدل بالنسبة للجميع، فنقاط الانطلاق، وأرضية الحوار، والمفاهيم مختلفة بالنسبة للأطراف.
فنقطة البداية بالنسبة للفلسطينيين هي أنهم عاشوا على أرضهم لقرون عندما كانت تلك الأرض جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي فإن انهيارها، يجعلهم، كسكان لهذا البلد، المحال لهم هذا الجزء من الدولة، أصحاب تلك الأراضي بصكوك الملكية الصادرة عن الإمبراطورية العثمانية. أما دولة إسرائيل الحديثة (1948)، فتنطلق من أسطورة أن هذه الأرض كانت مأهولة باليهود منذ آلاف السنين، ويريدون استعادة جزء منها على الأقل من أجل إحياء حلم الدولة اليهودية القديمة.
ومع كل الاحترام لهذه الفكرة الدينية المقدسة، المذكورة في الكتب السماوية، التي تحظى باحترام جزء كبير من البشرية، إلا أنه، وإذا كان اليهود في فلسطين كانوا يشكلون ولو حتى نصف تعداد السكان على الأقل في القرون الأخيرة قبل الحرب العالمية الثانية، لكان الأمر مقبولاً بعض الشيء، أما الحقيقة التاريخية فلها شواهد مرصودة ومؤرخة وبمقدرتنا قراءتها على سبيل المثال فيما كتب الرحالة أبرام نوروف، صديق شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين، وبطل الحرب الوطنية عام 1812، بعد أن زار فلسطين، ثلاثينيات القرن الماضي، وكشف لنا عن أن العرب المحليين والسوريين والأتراك واليونانيين يعيشون على أرض فلسطين، أما اليهود فكانوا أقلية صغيرة.
بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد المآسي التي مرت بها الأمة اليهودية في أوروبا، فضلاً عن الرواية الدينية والجذور التاريخية والأيديولوجية، قررت الأمم المتحدة إقامة دولتين على أرض فلسطين التاريخية وصرفت الوكالة اليهودية بسخاء على توطين اليهود في الدولة اليهودية المقامة حديثاً، لكن لم يتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية لرفض الفلسطينيين والعرب التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين التاريخية وبقيت في حينها الأراضي التي حددها قرار التقسيم تحت الوصاية الأردنية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن روسيا اعترفت بالدولة الفلسطينية، وكذلك فعلت جميع الدول والشعوب المحبة للسلام، مع ملاحظة عدم إحراز أي تقدم على الأرض الفلسطينية، وتغوّل الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الأراضي.
تكتسب القضية الفلسطينية اليوم زخماً جديداً مع تغير العالم من حولنا، ومع ما نلاحظه من أفول لهيمنة الولايات المتحدة وضغط كتلة “الناتو” التي تخسر كل يوم أمام حركة الشعوب نحو المساواة، ونحو علاقات صادقة ومحترمة بين الدول بغض النظر عن حجمها وإنجازاتها الاقتصادية. وإذا كانت البشرية تسعى إلى تقليل إمكانية المواجهة النووية بين القوى العظمى، وتستبعد ظهور حريق عالمي جديد، فعليها أن تسعى جاهدة للقضاء على النقاط الساخنة حول العالم، والصراعات التي حتمل أن تكون خطرة ليس فقط على اللاعبين الإقليميين، وإنما كذلك على إمدادات الطاقة، وبالتالي على المستوى الدولي، لا سيما الصراح المحتمل جداً بين إسرائيل وإيران.
فليس من الصعب على أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وعلى صقور إسرائيل، أن تجد سبباً لاندلاع مواجهة واسعة النطاق، خاصة وأن الاتفاق الجديد، الزلزال السياسي الحقيقي، الذي فجرته الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران، لم يحدث بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو بوساطة أي من القوى التي تلعب دور رسل السلام والحرية والديمقراطية حول العالم. كانت روسيا والصين في خلفية هذا الاتفاق المؤثر، وهو ما يجعل إسرائيل، واتفاقاتها الفردية مع بعض الدول العربية خالية من المضمون. ذلك أن وضع قوى مثل حزب الله، ومثل سوريا، ومحور المقاومة، وعلاقته بالمكون السني حول العالم العربي ستتغير بسبب هذا الاتفاق، ناهيك عن أن نظرية الأمن الخليجي، التي كانت حتى عهد قريب ترتبط ارتباطاً عضوياً بوجود القواعد الأمريكية هناك، سوف تكون الآن محل نقاش، لا سيما وأن نفقاتها تصبح غير مبررة وغير ذات نفع، بل وتمثل خطورة على دول المنطقة، حال اندلاع صراعات لا دخل للمنطقة بها.
وبهذه المناسبة أرى أنه من غير الدقيق استخدام مصطلح “التطبيع” مع إسرائيل بالنسبة للدول التي أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني، ذلك أن علاقات بعض الدول العربية مع إسرائيل، وبالاحتكاك مع مسؤوليها رفيعي المستوى، تهدف إلى دعم عملية التوصل إلى سلام عادل وشامل ومساعدة الفلسطينيين وليس أكثر من ذلك، وقد أكد لي الجميع بلا استثناء على أنه لا تنازل بأي شكل من الأشكال عن الحق الفلسطيني، وإنما هي وسيلة من وسائل الدعم لا أكثر.
لهذا يصبح من المنطقي أن تعرقل الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها في “الناتو” أي إمكانية لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن الملف النووي، لأنهم يدفعون إسرائيل لشن ضربة جديدة ضد إيران، على الرغم من أن معظم الخبراء في مجال الطاقة والأسلحة النووية يجزمون بأن إيران فعلياً لا تنوي صنع أسلحة نووية، لأن ذلك ليس من مصلحة إيران، وسيؤدي إلى استفزاز إسرائيل لضرب منشآتها، كما أنه من المستحيل في العالم الحديث الكذب حول هذا الأمر، والوسائل التقنية الحديثة للاستطلاع والمراقبة عبر الأقمار الصناعية وشبكات العملاء قادرة على كشف ذلك.
إلا أن الحرب الحديثة، وهو ما نراه أمام أعيننا في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، أصبحت تعتمد بشكل كبير على وسائل تدمير أكثر تقدماً وأقل تكلفة، فإيران، على سبيل المثال، قد لا تمتلك في واقع الأمر قوة جوية حديثة، لكنها قامت ببناء أسطول واسع من الطائرات المسيّرة، التي تزود بها بعض الميليشيات الشيعية في بلدان أخرى، وتلك قوة أخرى ضاربة لم تكن في الحسبان.
وبغرض الحسابات النظرية لا أكثر، فإن القوة الإسرائيلية المضادة للصواريخ اليوم تمتلك 10 بطاريات في كل منها 4 قاذفات، وهي قادرة على إطلاق ما يصل إلى 20 صاروخاً مضاداً، أي أننا نتحدث عن 800 صاروخ معترض، وهو رقم ضخم، ورقم قادر على حماية سماء إسرائيل، لكن، ماذا بعد؟ ما الفرق بين تكلفة الصاروخ الواحد، وتكلفة 10 أو 100 طائرة مسيرة انتحارية؟
إن أفضل استراتيجية لبلد صغير ومكتظ بالسكان هي قدرته على حفظ السلام والأمن لمواطنيه، أي فن التفاوض مع الجيران، وإيجاد حلول للتعايش مع الفلسطينيين، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وخفض حدة الخطاب العدواني، والأهم من ذلك، وضع مصالح شعبه أولاً، وليس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.
لا يحتاج الشرق الأوسط إلى قنابل ذرية، وإنما يحتاج إلى جهود حقيقية مخلصة لحفظ السلام، وربما وحدات لحفظ السلام من دول مختلفة، ولروسيا في هذا الصدد خبرة عمرها نصف قرن في حفظ السلام بالمناطق الساخنة، وأعتقد أنها على استعداد دائماً للمشاركة في حفظ السلام، جنباً إلى جنب مع وحدات من جميع القارات.
أظن أن علينا اليوم التركيز على إجبار إسرائيل وبإرادة دولية مجتمعة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص تقسيم فلسطين إلى دولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ثم إطلاق المحادثات بين الدولتين الفلسطينية والعبرية فوراً دون أي مماطلة.
يجب على المجتمع الدولي الذي يسعى لإجبار إسرائيل على “التفاوض” أن يجبرها على “مغادرة” جميع الأراضي التي تمثل حدود الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، أما وسائل الفلسطينيين لتحرير أراضيهم المحتلة، فذلك الكفاح المسلح هو حق مشروع دوليا عندما تحتل دولة أراضي دولة أخرى معترف بها.
في بداية السنة، وأثناء الأحداث في جنين، ناشدت في مقال لي أن يتم إعلان هذا العام عام فلسطين تخليداً لشهداء جنين، والذين كان عددهم حينها 10. اليوم أصبح عدد الشهداء منذ بداية العام 100 من الضفة الغربية وغزة، وأكرر بضرورة أن تقوم جامعة الدول العربية بالمبادرة على حث جميع دول العالم للبدء في المفاوضات مع إسرائيل مطالبين بالانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ينسحب بالدرجة الأولى على القدس الشريف، وكذلك العمل على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار أممي خاص بهذا الشأن، وأن يقوم وفد عربي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بلقاء المجموعة الرباعية الدولية الخاصة بالتسوية الفلسطينية (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) وحثهم إسرائيل على الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة.
قيام الدولة الفلسطينية أولاً، ثم نتفاوض مع الدولة الإسرائيلية حول القضايا المشتبكة والمعلّقة.
#مرايا_الدولية